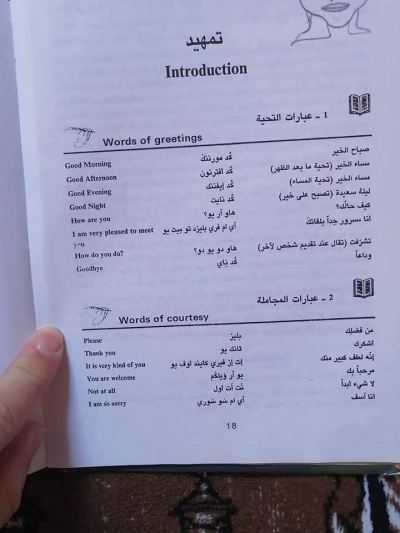المثقف والأمن الفكري (1- 8)

لا شك أن المثقف الجاد يمثل صوت المجتمع وضميره، ويمثل السياج المنيع في المحافظة على التنمية وتعزيز الأمن الفكري في عطائه، وسلوكه ومواقفه، وفي اضطلاعه بأمانة الكلمة، وحمل الرسالة، دفاعًا، وتوجيهًا وتوعية وتبصيرًا بقضايا وهموم الوطن ومصالحه، فالأوطان تشقى وتمرض بمثقفيها أو تسعد وتقوى بهم. أليس من المفارقات التي تثير العجب أن يكون المثقفون في الدول المتحضرة هم عقولها المفكرة وطليعتها المدافعة عنها، وعن أمنها وتاريخها ورجالها، في حين تشقى المجتمعات العربية ببعض مثقفيها؟
إن التزاحم في الفضاء الواقعي والافتراضي، وتداخل الثقافات والمؤثرات جعل الدول تعمل على تعزيز ثقافتها وهويتها الوطنية وترسيخ مشاعر الانتماء لدى مواطنيها، من خلال أنساق وعمليات تربوية وثقافية، تبدأ من الأسرة إلى المدرسة، ثم الجامعة، وعبر مستويات مختلفة ثقافية وتربوية وإعلامية واجتماعية تحكمها قيم ومبادئ وأطر تشريعية وإستراتيجيات مدروسة.
في الواقع إن ضعف الثقافة والهوية الوطنية ومشاعر الانتماء لا ينتج عن اختلال فكري وعقدي فحسب، بل قد يعزى إلى اختلال المنظومة التربوية والدينية والاقتصادية والإعلامية في تلبية متطلبات التربية والرعاية والاحتياجات الأساسية للفرد والمجتمع. ولهذا كان دور المثقف الجاد وقدرة العمل على تجسير العلاقة بين مختلف الأطياف الثقافية، والمشارب والاتجاهات المتنوعة لخدمة الأهداف الكبرى، من خلال مشاركاته المؤثرة وإسهاماته بحكم كونه في الأصل أو يفترض أن يكون تواقًا للانفتاح المعرفي، يتذوّق وينقد ببصيرة نافذة، وعمق في الثقافة، ويتكئ على منظومة ثقافية وفكرية يوظفها في البناء والنهوض ومواجهة مهدداتهما عبر حضوره التنوري الفاعل والحيوي في المجتمع؛ بحيث يشكل في المحصلة النهائية أنموذجًا وطنيًا للإنسان الواعي المؤثر في المجتمع، بعيدًا عن ثقافة التترس وراء التخصص العلمي، كما فعل الكثيرون في هذا الزمن.
وبنظرة أكثر عمقًا لا بد أن نشير إلى تعرض بعض المثقفين العرب إلى مواقف أدت إلى تشظيهم، وتلبسهم باتجاهات مختلفة، فهنالك من اغترب واتجه مع الثقافة الغربية، ومنهم من اتجه إلى الأنشطة الحزبية، ومنهم من تقوقع على ذاته، وهناك من يمجد نفسه زاعمًا أنه من يمتلك الحقيقة، وأنه ضحية إهمال وتهميش, وكأن لسان حاله يقول: «أضاعوني وأيَّ فتًى أضاعوا»
وثمة ملاحظة في هذ السياق وهي أن «المثقف» العربي احتل مساحة واسعة في ميزان اهتمام الباحثين والأكاديميين؛ لما تمثله كفة القلم في استتباب الأمن على كفة القوة والسيف، ولم تكن كتابات إدوارد سعيد وعلي حرب، وعبد الله العروي، ونعوم اتشومسكي، وريتشارد بوزنر، وبسكال بونيفاس إلا نماذج من ذلك الكم الكبير من الاهتمام بالمثقف والمثقفين، على أنه يوجد في كل أمة «مثقف نخبوي»، وآخر مثقف مجدد، ومثقف ناقد، ومثقف ساخر، ومثقف موظف، ومثقف عبء على الثقافة إلى غير ذلك، وعلى الدوام كان من أهم أدوات المثقف هو: الحوار والنقد والتنوير؛ لأنه حامل الرسالة وناشر الوعي والتنوير، ومشيعهما في المجتمع إعمارًا للأرض ومكافحة لدعاة التطرف والغلو والجفاء، ومعتنقي العنف، ومصادرة الحريات المشروعة.
إن المثقف المتبصر هو في عداد المنقذين الحقيقيين من التخلف والضلال والانحراف والإرهاب، وهو الحصن الذي يلوذ إليه المجتمع، وخاصة المتمدنين لطرد أدعياء الغيرة على المبادئ والقيم، ومرددي الشعارات والشائعات والأكاذيب، والتضليل والتخلف، يقول بعض الفلاسفة: «إن التغيير الحقيقي للبنى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا يتم في رأيه إلا عن طريق «المثقف» فهو صانع التاريخ وأحد محركاته، كما أنه فضلًا عن ذلك يعتبر بمثابة روح المجتمع وقلبه النابض، وإن من يظل أسيرًا لمكتبه وأوراقه وعالمه الخاص في برجه العاجي، ليس مثقفًا مصلحًا، فالمثقف إنما هو شخصية متشبعة بهموم الواقع منغمسة أيما انغماس في المجتمع.
ولا نحب أن نتطرق للعلاقة بين المثقف والسلطة في العالم العربي التي لا أحد ينكر أنها مرت بظروف وتضاريس شائكة، منها ما هو متوتر وملتبس، ومنها ما هو وثيق التلاحم والانسجام، وما يمكن قوله هو أن هناك فئة من المثقفين العرب يمكن أن يقال: إنها مصابة بداء العظمة والتمترس خلف رؤيتها وشعاراتها وإنجازاتها الوهمية، تمطر أتباعها بالأحلام السرابية، متجاهلين أن المثقف الحقيقي هو المسكون بهموم أمته، ويمثل تطلعاتها وأمنها، وهو في نفس الوقت وسيط متنور يهتم بالثوابت بين الفعاليات المؤثرة وشرائح المجتمع بعيدًا عن المراهقة الثقافية والتقليد الأعمى للآخر، على أنه في كل الأحوال تظل أزمة المثقف العربي أو لنقل بعضهم ليست في الحرية على أهميتها، إنما هي في إصابتهم بوباء تضخيم الذات والاستعلاء والنظر لقضايا الأمة من أبراج عاجية لا تلامس الواقع والسياقات التاريخية والواقعية.
لقد ابتلي العالم العربي والإسلامي بموجات وتيارات هدامة متنوعة تستهدف أهم ركائز الثقافة والهوية والانتماء؛ حيث جاءت موجات منها ما يسمى موجة «تصدير الثورات والقوميات والانقلابات والمد الماركسي» وحين عجزت تلك المحاولات التعيسة التي تهدف إلى النيل من أمن الدول المستهدفة، وأعيت أصحابها الحيل، والإفلاس على جميع المستويات، لم يملكوا إلا تدبير الدسائس والمؤامرات، واختطاف فكر فئة من شباب الأمة المغرر بهم تحت شعارات زائفة وذرائع واهية، وفتاوى مضللة.
وفى نظرة إلى الوراء قليلاً نجد أنه بعد غزو الاتحاد السوفيتي السابق لأفغانستان مع بدايات الثمانينيات من القرن الماضي، ومع استيلاء الهالك الخميني على إيران، وما تلا ذلك من أحداث وإرهاصات قادت بالتالي إلى نشوء صراعات فكرية وقتالية في أفغانستان، حيث اعتنق البعض الغلو والتطرف والتكفير من خلال عمليات الاستدراج والتغرير والتجنيد وغسل الأدمغة، بتأثير من قوى وجماعات متشددة معادية، منها جماعة ما يسمى بالإخوان المسلمين ومن خرج من عباءتها من التكفيريين الذين انبروا إلى تنصيب أنفسهم قضاة على المجتمعات العربية والإسلامية، مع جهل واضح بمقاصد الشريعة الإسلامية والواقع، فضلًا عن طغيان التناقضات والإحباطات في حياتهم التي تجسدت في قضايا الجهاد والولاء والبراء والتكفير وغيرها من الشبهات التي أصبحت تهيمن على عقولهم وتحكم تصرفاتهم.
والحق أن الأمة العربية قد فجعت بأحداث ما يسمى «الربيع العربي» حيث أطلق من خلاله عنان الصراعات، والمليشيات والجماعات والمنظمات الإرهابية الإخوانجية لتعبث بالمجتمعات وترهب الناس وتروعهم، وانفجرت تيارات العرقيات والمذاهب والطوائف، والصراعات، والحروب الأهلية، وبرزت المصالح الضيقة والفئوية، والولاءات الفرعية، والانفلات الأمني، وانتشار السلاح في ظل استمرار تفاقم أزماتهم الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وغياب الثقافة الراسخة والإستراتيجيات المدروسة.
وفي هذه الأجواء الإقليمية والدولية المشحونة بفكر التكفير والتفجير، لم يعدم المؤدلجون اليائسون طريقًا للتنفيس عن فكرهم بارتكاب الأعمال الإرهابية، واستمر التحريض من خلال أساليب كثيرة منها: الأشرطة والكتب والأصدقاء والرحلات، والمطبوعات الدورية وأخيرًا عبر مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي التي كانت تعبر عن آرائهم وتوجهاتهم.
وتعرضت المملكة خاصة لهجمات إرهابية تحت مختلف العناوين والمنطلقات السياسية والأيديولوجية منذ الستينيات في القرن الماضي، وهذا ما يتناساه كثيرون، حيث تصدت بقوة وحزم للإرهاب على مستويات عدة، وحققت من خلال الأجهزة الأمنية إنجازات كبيرة لا نظير لها، ونجحت في توجيه الضربات الاستباقية، وإفشال الكثير من العمليات الإرهابية.
ومن منطلق قراءة جديدة لفكر التكفير والتفجير برزت الحاجة إلى مزيد الاهتمام بصناعة الأمن الفكري وجعله مشروعًا حضاريًا يخاطب الإنسانية؛ انطلاقًا من أن الفكر لا يقاوم إلا بالفكر، وأنه المفتاح الحقيقي لمواجهة التيارات الهدامة، والمرتكز الأهم لحماية الوحدة الوطنية، وتحقيق الأمن والرخاء الاقتصادي، والرفاهية الاجتماعية، بعيدًا عن الانحرافات الفكرية، والفرقة والتناحر، وضياع الحقوق، وسفك الدماء، وانتهاك الأعراض.
واستمر المثقف العربي الجاد يؤدي دورًا أساسيًّا في تكوين صور السلوك والتفكير والعواطف الإيجابية، ويقدم تفسيراتٍ وتوضيحاتٍ عن العالم والحياة، ويبصر بالثوابت التي تمكّن الفرد من التمييز بين الخير والشر، وبين الأفعال الصحيحة والخاطئة، فضلًا عن السعي الحثيث إلى تقوية الروابط بين أبناء مجتمعه، وتوخي نشر المبادئ والاتجاهات الصحيحة التي تحسّن من سلوك الفرد وتنهض به، بحيث ينسجم مع السلوكيّات المتعارف عليها.
فإن قِيل مَن فتى خِلتُ أنني
عُنيتُ فلم أكسل ولم أتبلدِ
إن التزاحم في الفضاء الواقعي والافتراضي، وتداخل الثقافات والمؤثرات جعل الدول تعمل على تعزيز ثقافتها وهويتها الوطنية وترسيخ مشاعر الانتماء لدى مواطنيها، من خلال أنساق وعمليات تربوية وثقافية، تبدأ من الأسرة إلى المدرسة، ثم الجامعة، وعبر مستويات مختلفة ثقافية وتربوية وإعلامية واجتماعية تحكمها قيم ومبادئ وأطر تشريعية وإستراتيجيات مدروسة.
في الواقع إن ضعف الثقافة والهوية الوطنية ومشاعر الانتماء لا ينتج عن اختلال فكري وعقدي فحسب، بل قد يعزى إلى اختلال المنظومة التربوية والدينية والاقتصادية والإعلامية في تلبية متطلبات التربية والرعاية والاحتياجات الأساسية للفرد والمجتمع. ولهذا كان دور المثقف الجاد وقدرة العمل على تجسير العلاقة بين مختلف الأطياف الثقافية، والمشارب والاتجاهات المتنوعة لخدمة الأهداف الكبرى، من خلال مشاركاته المؤثرة وإسهاماته بحكم كونه في الأصل أو يفترض أن يكون تواقًا للانفتاح المعرفي، يتذوّق وينقد ببصيرة نافذة، وعمق في الثقافة، ويتكئ على منظومة ثقافية وفكرية يوظفها في البناء والنهوض ومواجهة مهدداتهما عبر حضوره التنوري الفاعل والحيوي في المجتمع؛ بحيث يشكل في المحصلة النهائية أنموذجًا وطنيًا للإنسان الواعي المؤثر في المجتمع، بعيدًا عن ثقافة التترس وراء التخصص العلمي، كما فعل الكثيرون في هذا الزمن.
وبنظرة أكثر عمقًا لا بد أن نشير إلى تعرض بعض المثقفين العرب إلى مواقف أدت إلى تشظيهم، وتلبسهم باتجاهات مختلفة، فهنالك من اغترب واتجه مع الثقافة الغربية، ومنهم من اتجه إلى الأنشطة الحزبية، ومنهم من تقوقع على ذاته، وهناك من يمجد نفسه زاعمًا أنه من يمتلك الحقيقة، وأنه ضحية إهمال وتهميش, وكأن لسان حاله يقول: «أضاعوني وأيَّ فتًى أضاعوا»
وثمة ملاحظة في هذ السياق وهي أن «المثقف» العربي احتل مساحة واسعة في ميزان اهتمام الباحثين والأكاديميين؛ لما تمثله كفة القلم في استتباب الأمن على كفة القوة والسيف، ولم تكن كتابات إدوارد سعيد وعلي حرب، وعبد الله العروي، ونعوم اتشومسكي، وريتشارد بوزنر، وبسكال بونيفاس إلا نماذج من ذلك الكم الكبير من الاهتمام بالمثقف والمثقفين، على أنه يوجد في كل أمة «مثقف نخبوي»، وآخر مثقف مجدد، ومثقف ناقد، ومثقف ساخر، ومثقف موظف، ومثقف عبء على الثقافة إلى غير ذلك، وعلى الدوام كان من أهم أدوات المثقف هو: الحوار والنقد والتنوير؛ لأنه حامل الرسالة وناشر الوعي والتنوير، ومشيعهما في المجتمع إعمارًا للأرض ومكافحة لدعاة التطرف والغلو والجفاء، ومعتنقي العنف، ومصادرة الحريات المشروعة.
إن المثقف المتبصر هو في عداد المنقذين الحقيقيين من التخلف والضلال والانحراف والإرهاب، وهو الحصن الذي يلوذ إليه المجتمع، وخاصة المتمدنين لطرد أدعياء الغيرة على المبادئ والقيم، ومرددي الشعارات والشائعات والأكاذيب، والتضليل والتخلف، يقول بعض الفلاسفة: «إن التغيير الحقيقي للبنى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا يتم في رأيه إلا عن طريق «المثقف» فهو صانع التاريخ وأحد محركاته، كما أنه فضلًا عن ذلك يعتبر بمثابة روح المجتمع وقلبه النابض، وإن من يظل أسيرًا لمكتبه وأوراقه وعالمه الخاص في برجه العاجي، ليس مثقفًا مصلحًا، فالمثقف إنما هو شخصية متشبعة بهموم الواقع منغمسة أيما انغماس في المجتمع.
ولا نحب أن نتطرق للعلاقة بين المثقف والسلطة في العالم العربي التي لا أحد ينكر أنها مرت بظروف وتضاريس شائكة، منها ما هو متوتر وملتبس، ومنها ما هو وثيق التلاحم والانسجام، وما يمكن قوله هو أن هناك فئة من المثقفين العرب يمكن أن يقال: إنها مصابة بداء العظمة والتمترس خلف رؤيتها وشعاراتها وإنجازاتها الوهمية، تمطر أتباعها بالأحلام السرابية، متجاهلين أن المثقف الحقيقي هو المسكون بهموم أمته، ويمثل تطلعاتها وأمنها، وهو في نفس الوقت وسيط متنور يهتم بالثوابت بين الفعاليات المؤثرة وشرائح المجتمع بعيدًا عن المراهقة الثقافية والتقليد الأعمى للآخر، على أنه في كل الأحوال تظل أزمة المثقف العربي أو لنقل بعضهم ليست في الحرية على أهميتها، إنما هي في إصابتهم بوباء تضخيم الذات والاستعلاء والنظر لقضايا الأمة من أبراج عاجية لا تلامس الواقع والسياقات التاريخية والواقعية.
لقد ابتلي العالم العربي والإسلامي بموجات وتيارات هدامة متنوعة تستهدف أهم ركائز الثقافة والهوية والانتماء؛ حيث جاءت موجات منها ما يسمى موجة «تصدير الثورات والقوميات والانقلابات والمد الماركسي» وحين عجزت تلك المحاولات التعيسة التي تهدف إلى النيل من أمن الدول المستهدفة، وأعيت أصحابها الحيل، والإفلاس على جميع المستويات، لم يملكوا إلا تدبير الدسائس والمؤامرات، واختطاف فكر فئة من شباب الأمة المغرر بهم تحت شعارات زائفة وذرائع واهية، وفتاوى مضللة.
وفى نظرة إلى الوراء قليلاً نجد أنه بعد غزو الاتحاد السوفيتي السابق لأفغانستان مع بدايات الثمانينيات من القرن الماضي، ومع استيلاء الهالك الخميني على إيران، وما تلا ذلك من أحداث وإرهاصات قادت بالتالي إلى نشوء صراعات فكرية وقتالية في أفغانستان، حيث اعتنق البعض الغلو والتطرف والتكفير من خلال عمليات الاستدراج والتغرير والتجنيد وغسل الأدمغة، بتأثير من قوى وجماعات متشددة معادية، منها جماعة ما يسمى بالإخوان المسلمين ومن خرج من عباءتها من التكفيريين الذين انبروا إلى تنصيب أنفسهم قضاة على المجتمعات العربية والإسلامية، مع جهل واضح بمقاصد الشريعة الإسلامية والواقع، فضلًا عن طغيان التناقضات والإحباطات في حياتهم التي تجسدت في قضايا الجهاد والولاء والبراء والتكفير وغيرها من الشبهات التي أصبحت تهيمن على عقولهم وتحكم تصرفاتهم.
والحق أن الأمة العربية قد فجعت بأحداث ما يسمى «الربيع العربي» حيث أطلق من خلاله عنان الصراعات، والمليشيات والجماعات والمنظمات الإرهابية الإخوانجية لتعبث بالمجتمعات وترهب الناس وتروعهم، وانفجرت تيارات العرقيات والمذاهب والطوائف، والصراعات، والحروب الأهلية، وبرزت المصالح الضيقة والفئوية، والولاءات الفرعية، والانفلات الأمني، وانتشار السلاح في ظل استمرار تفاقم أزماتهم الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وغياب الثقافة الراسخة والإستراتيجيات المدروسة.
وفي هذه الأجواء الإقليمية والدولية المشحونة بفكر التكفير والتفجير، لم يعدم المؤدلجون اليائسون طريقًا للتنفيس عن فكرهم بارتكاب الأعمال الإرهابية، واستمر التحريض من خلال أساليب كثيرة منها: الأشرطة والكتب والأصدقاء والرحلات، والمطبوعات الدورية وأخيرًا عبر مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي التي كانت تعبر عن آرائهم وتوجهاتهم.
وتعرضت المملكة خاصة لهجمات إرهابية تحت مختلف العناوين والمنطلقات السياسية والأيديولوجية منذ الستينيات في القرن الماضي، وهذا ما يتناساه كثيرون، حيث تصدت بقوة وحزم للإرهاب على مستويات عدة، وحققت من خلال الأجهزة الأمنية إنجازات كبيرة لا نظير لها، ونجحت في توجيه الضربات الاستباقية، وإفشال الكثير من العمليات الإرهابية.
ومن منطلق قراءة جديدة لفكر التكفير والتفجير برزت الحاجة إلى مزيد الاهتمام بصناعة الأمن الفكري وجعله مشروعًا حضاريًا يخاطب الإنسانية؛ انطلاقًا من أن الفكر لا يقاوم إلا بالفكر، وأنه المفتاح الحقيقي لمواجهة التيارات الهدامة، والمرتكز الأهم لحماية الوحدة الوطنية، وتحقيق الأمن والرخاء الاقتصادي، والرفاهية الاجتماعية، بعيدًا عن الانحرافات الفكرية، والفرقة والتناحر، وضياع الحقوق، وسفك الدماء، وانتهاك الأعراض.
واستمر المثقف العربي الجاد يؤدي دورًا أساسيًّا في تكوين صور السلوك والتفكير والعواطف الإيجابية، ويقدم تفسيراتٍ وتوضيحاتٍ عن العالم والحياة، ويبصر بالثوابت التي تمكّن الفرد من التمييز بين الخير والشر، وبين الأفعال الصحيحة والخاطئة، فضلًا عن السعي الحثيث إلى تقوية الروابط بين أبناء مجتمعه، وتوخي نشر المبادئ والاتجاهات الصحيحة التي تحسّن من سلوك الفرد وتنهض به، بحيث ينسجم مع السلوكيّات المتعارف عليها.
فإن قِيل مَن فتى خِلتُ أنني
عُنيتُ فلم أكسل ولم أتبلدِ