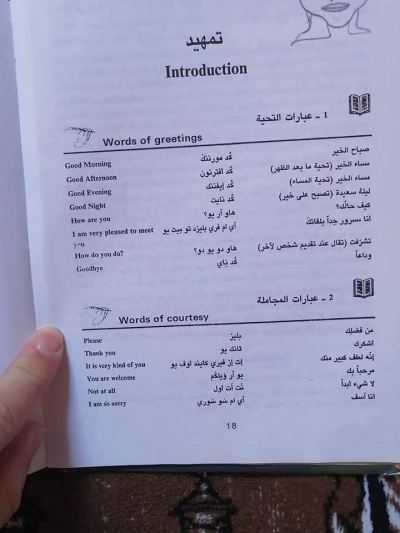بناء الوطن بالنيابة

بناء الوطن بالنيابة
يقول ابن الرومي :
وحبّب أوطانّ الرجالِ إليهم *** مآربُ قضاها الشبابُ هنالكا
إذا ذكروا أوطانهم ذكّرتهمُ *** عهودَ الصبا فيها فحنوا لذلكا
ويقول أحمد شوقي :
وطني لو شُغلتُ بالخُلد عنه *** نازعتني إليه في الخلد نفسي.
تمثل قصيدة ابن الرومي أول ذكر صريح للوطن والأوطان في الشعر العربي ، أما أمير الشعراء فقد أُبعد عن بلده مصر ونفي إلى إسبانيا، فشعر بالحنين إلى وطنه فجاءت قصائده الوطنية معبرّةً عن ذلك الحنين..
ومن المعروف أن الشعر الوطني في كل بلدان العالم من أبرز التجارب وأقواها في تجربة الشاعر .
لن أتحدث عن الوطن والشعر فهذا باب واسع ومجال عظيم لإبراز قيمة الوطن وشعور الشاعر نحوه.
سأتحدث عن حيرة بعض المؤسسات والثقافية تحديداً كيف تحيي مناسبة اليوم الوطني ؟
تنهال الاقتراحات وتتبارى الأصوات وقد تعلو الآراء التي تقترح محاضرة وطنية أوأمسية شعرية. وقد يفصّل أحدهم فيتحدث عن ضرورة أن تكون المحاضرة عن سلبيات وإيجابيات التعبيرعن الفرح باليوم الوطني !
ومن غيرما شك، فإن المناسبة الغالية على قلوبنا والذكرى المتجددة المعطرِّة لتقويمنا السنوي كل عام تستحق هذا التخطيط ويجب أن تحتوي على كل هذه الأفكار المتبارية في إعلاء شأن الوطن وتأكيد الانتماء له ليبقى عالياً شامخاً بكل تاريخه مكلّلاً بأمجاده.
وليس أجمل في هذا السياق أن يأتي الحديث شعرا أو نثراً ليجدد العهد وليوقد في النفوس مشاعل الذكرى عن الوطن ورجالاته وعلى رأسهم الملك المؤسس عبد العزيز طيب الله ثراه .
في الأيام القادمة ،ستمتلئ مجالسنا بأحاديث من نوع :
(إن الأجيال اليوم لم تقدّر الوطن حق قدره)...ويرى كبير سنّ (أن الشباب يبذرون الفوضى في الشوارع ويعطون صورة سلبية عن شكل الفرح ومعناه!)
ويقول رجل المرور (إن الفرح لا يبرر قطع الإشارة والتفحيط وتعطيل الحركة ..)ويقول طامعٌ في الفتوى: (إن ما أفضى إلى منكر فهو حرام!) ويقول متفرج(إن الفرح لا يبرر التعدي على منجزات الوطن ، ولا لتعريض حياة الآخرين للخطر ..أين احترام النظام بكل مكوناته!؟)
صاحب رأي حصيف ورؤية صافية يرى أن الأمر يجب ألا يتجه كل مرة إلى الانتقاد لهؤلاء القلة الذين تجاوز فرحُهم الحدود وأساؤوا دون قصد أو تصرفوا باندفاع غير محسوب .. إذ أن المطلوب إظهار الفرح وليس الكبت، ونحن نعرف أن الكبت قد يفضي إلى ظواهر سلبية وأشكال من التخريب وربما يصل الأمر إلى التعدي شبه المخطط له ! والحوادث في السنوات الماضية خير دليل على ما أقول!
لن أستمر في حديث الظواهر السلبية والإيجابية في اليوم الوطني التي سنراها تملأ الشوارع وتصطبغ بها السيارات والوجوه، وترفرف بها الأعلام في الشوارع والساحات.وسنرى بهجة وتعبيراً احتاج الأمر إلى سنين طويلة للاعتراف بهما ،وخُصّص للمناسبة عطلةٌ للنوم أو لبذر الفرح ملوّناً في الشوارع !
سأضرب صفحاً عن هذا ، وأتحدث عن جذور هذه التصرفات ..مركّزاً على مسألة مهمة، وهي أن الشاب في هذا الوطن المعطاء اعتاد على الأخذ ولم يتعوّد على العطاء بشكله الممنهج المغروس عبر نظام تربوي منزلي ومدرسي؛ لم يتشرب قيم العطاء من المنزل ليكون التطبيق في الشارع عفوياً وتلقائياً. لم يُعوّد هذا الشاب على العطاء، وهذا من نواتج عدم تحمّل المسؤولية وطرح العمل جانباً .
من يستطيع أن يخبرني: ما معنى العطاء لشاب في العشرين فليفعل! أراهن على أننا كمجتمع نتحدث عن العطاء والبذل ولم نجعلهما (سلوكاً وطنياً).. لم نرقّق طباع أبنائنا وبناتنا ليكون العطاء جزءاً من شخصياتهم ، العطاء الحقيقي لا العطاء المزيف والمفتعل! ومن لا يوافقني ليشاهد ما يبثّ عبر الفديوهات وشبكات التواصل و(الواتس أب) على أنه برّ فلان بأمه! يجب أن نتذكر أن العطاء الحقيقي لا يأتي من تعبير لحظي ولا عبر شعار استعراضي كما في حملة الاستغفار!
لابد من المصارحة بحقيقة الأمر كما يظهر ..إن الشاب خصوصا والمواطن عموماً يمرّ كل منهما على المنجز الحضاري والعمراني والتنموي سريعاً دون تأنِّ ولا تروِّ لكي يرى ويشعر ويدرك مقدار البناء الذي تم في العقود الأخيرة .. ، المستعجل والمتأخر لا يرى إلا السلبيات التي من المؤكد أنها موجودة .لا يرى إلا مصلحته الذاتية فلا يعطي الدور لغيره في سرى أو دور أو طريق مزدحم . إنه الشاب المدجج بالتقنية المتقدمة المتأخرُ عن الموعد : موعد الحضور وموعد العطاء !!
لكي يشعر الشاب بالوطن ومنجزاته، فلا بد من أن يجالس كبار السن لا الأجداد فقط بل الآباء ليحدثوه عن الفارق بين الأمس القريب واليوم.
وليعمل الشاب في بعض الأعمال التطوعية للوطن، مساهماً ولو بجزء يسيرلأجل التنمية، لشارعه القريب مثلاً كي يشعر بالانتماء وليدرك أنه يحافظ على شيء بناه أو ساهم في بنائه ،أما أن يمر كل يوم على الوطن يُبنى في غيابه أو أثناء نومه تبنيه العمالة بالنيابة ! فلن يشعر بالانتماء الحقيقي الذي يجعله يحافظ على الوطن فلا يكسّر مرفقاً عاماً ولا يدمّر حديقة ولا يمزّق كتاباً ولا يحرق شجرة ولا يؤذي عاملاً شَرع في بناء الوطن نيابة عنه.
وحبّب أوطانّ الرجالِ إليهم *** مآربُ قضاها الشبابُ هنالكا
إذا ذكروا أوطانهم ذكّرتهمُ *** عهودَ الصبا فيها فحنوا لذلكا
ويقول أحمد شوقي :
وطني لو شُغلتُ بالخُلد عنه *** نازعتني إليه في الخلد نفسي.
تمثل قصيدة ابن الرومي أول ذكر صريح للوطن والأوطان في الشعر العربي ، أما أمير الشعراء فقد أُبعد عن بلده مصر ونفي إلى إسبانيا، فشعر بالحنين إلى وطنه فجاءت قصائده الوطنية معبرّةً عن ذلك الحنين..
ومن المعروف أن الشعر الوطني في كل بلدان العالم من أبرز التجارب وأقواها في تجربة الشاعر .
لن أتحدث عن الوطن والشعر فهذا باب واسع ومجال عظيم لإبراز قيمة الوطن وشعور الشاعر نحوه.
سأتحدث عن حيرة بعض المؤسسات والثقافية تحديداً كيف تحيي مناسبة اليوم الوطني ؟
تنهال الاقتراحات وتتبارى الأصوات وقد تعلو الآراء التي تقترح محاضرة وطنية أوأمسية شعرية. وقد يفصّل أحدهم فيتحدث عن ضرورة أن تكون المحاضرة عن سلبيات وإيجابيات التعبيرعن الفرح باليوم الوطني !
ومن غيرما شك، فإن المناسبة الغالية على قلوبنا والذكرى المتجددة المعطرِّة لتقويمنا السنوي كل عام تستحق هذا التخطيط ويجب أن تحتوي على كل هذه الأفكار المتبارية في إعلاء شأن الوطن وتأكيد الانتماء له ليبقى عالياً شامخاً بكل تاريخه مكلّلاً بأمجاده.
وليس أجمل في هذا السياق أن يأتي الحديث شعرا أو نثراً ليجدد العهد وليوقد في النفوس مشاعل الذكرى عن الوطن ورجالاته وعلى رأسهم الملك المؤسس عبد العزيز طيب الله ثراه .
في الأيام القادمة ،ستمتلئ مجالسنا بأحاديث من نوع :
(إن الأجيال اليوم لم تقدّر الوطن حق قدره)...ويرى كبير سنّ (أن الشباب يبذرون الفوضى في الشوارع ويعطون صورة سلبية عن شكل الفرح ومعناه!)
ويقول رجل المرور (إن الفرح لا يبرر قطع الإشارة والتفحيط وتعطيل الحركة ..)ويقول طامعٌ في الفتوى: (إن ما أفضى إلى منكر فهو حرام!) ويقول متفرج(إن الفرح لا يبرر التعدي على منجزات الوطن ، ولا لتعريض حياة الآخرين للخطر ..أين احترام النظام بكل مكوناته!؟)
صاحب رأي حصيف ورؤية صافية يرى أن الأمر يجب ألا يتجه كل مرة إلى الانتقاد لهؤلاء القلة الذين تجاوز فرحُهم الحدود وأساؤوا دون قصد أو تصرفوا باندفاع غير محسوب .. إذ أن المطلوب إظهار الفرح وليس الكبت، ونحن نعرف أن الكبت قد يفضي إلى ظواهر سلبية وأشكال من التخريب وربما يصل الأمر إلى التعدي شبه المخطط له ! والحوادث في السنوات الماضية خير دليل على ما أقول!
لن أستمر في حديث الظواهر السلبية والإيجابية في اليوم الوطني التي سنراها تملأ الشوارع وتصطبغ بها السيارات والوجوه، وترفرف بها الأعلام في الشوارع والساحات.وسنرى بهجة وتعبيراً احتاج الأمر إلى سنين طويلة للاعتراف بهما ،وخُصّص للمناسبة عطلةٌ للنوم أو لبذر الفرح ملوّناً في الشوارع !
سأضرب صفحاً عن هذا ، وأتحدث عن جذور هذه التصرفات ..مركّزاً على مسألة مهمة، وهي أن الشاب في هذا الوطن المعطاء اعتاد على الأخذ ولم يتعوّد على العطاء بشكله الممنهج المغروس عبر نظام تربوي منزلي ومدرسي؛ لم يتشرب قيم العطاء من المنزل ليكون التطبيق في الشارع عفوياً وتلقائياً. لم يُعوّد هذا الشاب على العطاء، وهذا من نواتج عدم تحمّل المسؤولية وطرح العمل جانباً .
من يستطيع أن يخبرني: ما معنى العطاء لشاب في العشرين فليفعل! أراهن على أننا كمجتمع نتحدث عن العطاء والبذل ولم نجعلهما (سلوكاً وطنياً).. لم نرقّق طباع أبنائنا وبناتنا ليكون العطاء جزءاً من شخصياتهم ، العطاء الحقيقي لا العطاء المزيف والمفتعل! ومن لا يوافقني ليشاهد ما يبثّ عبر الفديوهات وشبكات التواصل و(الواتس أب) على أنه برّ فلان بأمه! يجب أن نتذكر أن العطاء الحقيقي لا يأتي من تعبير لحظي ولا عبر شعار استعراضي كما في حملة الاستغفار!
لابد من المصارحة بحقيقة الأمر كما يظهر ..إن الشاب خصوصا والمواطن عموماً يمرّ كل منهما على المنجز الحضاري والعمراني والتنموي سريعاً دون تأنِّ ولا تروِّ لكي يرى ويشعر ويدرك مقدار البناء الذي تم في العقود الأخيرة .. ، المستعجل والمتأخر لا يرى إلا السلبيات التي من المؤكد أنها موجودة .لا يرى إلا مصلحته الذاتية فلا يعطي الدور لغيره في سرى أو دور أو طريق مزدحم . إنه الشاب المدجج بالتقنية المتقدمة المتأخرُ عن الموعد : موعد الحضور وموعد العطاء !!
لكي يشعر الشاب بالوطن ومنجزاته، فلا بد من أن يجالس كبار السن لا الأجداد فقط بل الآباء ليحدثوه عن الفارق بين الأمس القريب واليوم.
وليعمل الشاب في بعض الأعمال التطوعية للوطن، مساهماً ولو بجزء يسيرلأجل التنمية، لشارعه القريب مثلاً كي يشعر بالانتماء وليدرك أنه يحافظ على شيء بناه أو ساهم في بنائه ،أما أن يمر كل يوم على الوطن يُبنى في غيابه أو أثناء نومه تبنيه العمالة بالنيابة ! فلن يشعر بالانتماء الحقيقي الذي يجعله يحافظ على الوطن فلا يكسّر مرفقاً عاماً ولا يدمّر حديقة ولا يمزّق كتاباً ولا يحرق شجرة ولا يؤذي عاملاً شَرع في بناء الوطن نيابة عنه.
بقلم: الأستاذ ظافر الجبيري
المدائن